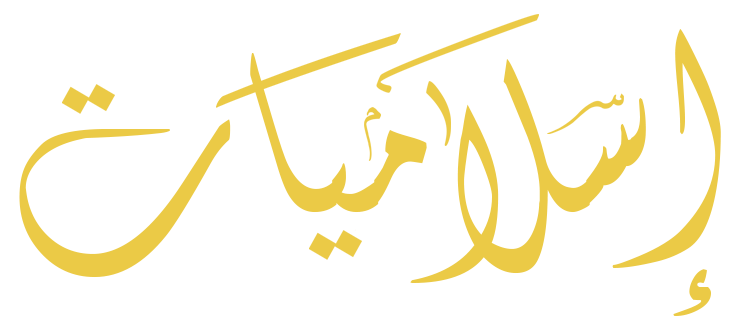اعتقادهم في علم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
قال المؤلف رحمه الله (قال تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه}—)
قال الشارح الشيخ احمد الحكمي:
ثم قال: وقوله: {إن ذلك على الله يسير}، أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها، طبق ما يوجد في حينها، سهل على الله، سهل على الله عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن، لو كان، كيف كان، وما لم يكن، لو كان، كيف كان يكون.
قال: وقوله: {لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم}، أي أعلمناكم بتقدم علمنا، وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها، وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم. فلا تأسوا على ما فاتكم، فإنه لو قُدّر شيء لكان، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي جاءكم.
قال: ولا تفرحوا بما آتاكم، أي جاءكم. ويُقرأ: “آتاكم”، أي أعطاكم، أو قال: ويُقرأ، أي في قراءة: “آتاكم”، أي أعطاكم، وكلاهما متلازمان. أي لا تفرحوا، أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدّكم، وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم. فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراً، تفخرون بها على الناس، ولهذا قال: {والله لا يحب كل مختال فخور}، أي مختال في نفسه، متكبر، فخور، أي على غيره. انتهى، والله أعلم.
اعتقادهم في القدر
قال المؤلف رحمه الله:
“يؤمنون بأنه كتب على العباد ما هم صائرون إليه من السعادة والشقاوة، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية، وغنى وفقر، وقوة وضعف، وصحة ومرض.”
قال الشارح الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي حفظه الله:
هذه الفقرة قد دل عليها عدة أدلة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً، فيؤمر بأربع كلمات: ويقال له: اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح)، الحديث.
ومن الأدلة أيضاً حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأذنيّ هاتين، يقول: (يا ربي أذكر أو أنثى؟) فيجعله الله ذكراً أو أنثى. ثم يقول: (يا ربي أسوي أو غير سوي؟) فيجعله الله سوياً أو غير سوي.
ثم يقول: (يا ربي ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟) ثم يجعله الله شقياً أو سعيداً.
وفي رواية: (ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف، فلا يزاد فيها ولا يُنقص).
أخرجهما الإمام مسلم رحمه الله في كتاب القدر، باب “كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته”.
ومن الأدلة أيضاً على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكاً، فيقول: أي ربي نطفة؟، فيقول: أي ربي نطفة. ثم يقول: أي ربي علقة؟، ثم يقول: أي ربي مضغة؟. فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً، قال الملك: أي ربي ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه).
فهذه الأدلة تدل دلالة صريحة على أن ذلك كله مكتوب.
اعتقادهم في القدر
قال المؤلف رحمه الله:
(وسيصير كل عبد منهم إلى ما هو مكتوب له أو عليه).
قال الشارح الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي حفظه الله:
قال السعدي رحمه الله: “فهو يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لها، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم أحوال المكلَّفين منذ أنشأهم، وبعد ما يميتهم، وبعد ما يحييهم (يعني من قبورهم) . قد أحاط علمه بأعمالهم كلها: خيرها وشرها، وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار.” انتهى.
وقوله، أي قول شيخنا رحمه الله: (وسيصير كل عبد منهم إلى ما هو مكتوب له أو عليه)، يعني يصير إليه يوم القيامة يوم أن يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم.
فالمؤمنون يهديهم الله بفضله، والكافرون يضلهم الله بعدله، وله فيهم الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة.
ويدل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بيّن لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فما العمل اليوم؟ أفيما جفَّت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: (لا، بل فيما جفَّت به الأقلام وجرت به المقادير). قال: ففيما العمل؟ قال: (اعملوا، فكل ميسَّر لما خلق له).
وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالساً وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: (ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة و النار).—قالوا: يا رسول الله، فلِمَ نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: (لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له)، ثم قرأ: {فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى}.
وفي رواية: (ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة)—فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟—فقال: (اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة). ثم قرأ {فأما من أعطى وأتقى..}
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، ونهى عن الاتكال على القدر، لأنه لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر في ترك الطاعة و فعل المعصية.
ولأن علم ذلك إلى الله وحده.
فمن احتج بالقدر فاحتجاجه باطل.
وليُعلم علم يقين أن الله جل وعلا لا يظلم أحداً.
وقال ابن كثير رحمه الله: الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعَّال لما يريد، العزيز الحكيم، العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية، وهو الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. الحكيم في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم. انتهى بتصرف.
وقال تعالى: {قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين}.
وقال العمراني في [الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار]:
“ويعتقد السلف أن الله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله.”
وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: (من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له).
وقال ابن القيم رحمه الله في [مدارج السالكين]:
“يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله وعطاؤه وما فضل الكريم بممنون، وهذا عدله وقضاؤه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.
قال المؤلف رحمه الله:
فالمؤمنون يهديهم الله بفضله، والكافرون يضلهم بعدله، وله فيهم الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة، لا يظلم ربنا أحداً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون {إنّ الله لا يظلم مثقال ذرة..} الاية.
الشيخ الشارح احمد الحكمي:
قال فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاوة كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه لا موفق إلا من وفقه الله وأعانه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلهاً ومعبوداً، فكان أحب إليه من كل ما سواه، أي من اعتقد هذا كان الله أحب إليه من كل ما سواه وأخوف عنده من كل ما سواه وأرجى له من كل ما سواه، فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، ثم قال ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخاوف، فتنساق المخاوف كلها تبعاً لخوفه، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء تبعاً لرجائه. انتهى.
وقال في طريق الهجرتين:
وأنه، أي أنه تعالى يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه، ولو شاء لخذلهم فعصوه، وأنه حال بين الكفار وقلوبهم، فإنه يحول بين المرء وقلبه، فكفروا به، ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه، وأنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. انتهى.
أقول: وذلك لعلمه تعالى أن هذا هو أهل للهداية، وذاك أهل للضلال، ولأن الله تعالى قد أعطى كل إنسان ما يميز به بين الحق والباطل، وأرسل إليه رسلاً، وأنزل عليه الكتب، ليميز الحق من الباطل، فمن ضل فبضلال نفسه، ومن اهتدى فبتوفيق الله له، يسره لليسرى، فعمل بطاعة الله، وتقرب إلى الله، وأما ذاك فاختار الضلالة على الهدى، وقد أمره الله باتباع الهدى، ولكنه أبى وتنكب هذا الطريق، وسار في طريق أهل الغواية والضلال، فظل، ولا يظلم ربك أحداً.
ولهذا قال الشيخ هنا رحمه الله: قال تعالى: {لا يظلم ربنا أحداً}، ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
قال تعالى: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً}.
أقول: وكذلك من الأدلة على أن الله جل وعلا لا يظلم أحداً قوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون}.
و”شيئاً” هنا نكرة في سياق النفي فتعم، فالله عز وجل لا يظلم عباده شيئاً أبداً.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حقت عليهم الضلالة.
وقوله تعالى: {وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}، أي هذه من الأدلة على أن الله عز وجل لا يظلم أحداً.
وقوله تعالى: {وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين}، قال ابن كثير: أي بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم، فكذبوا وعصوا، فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً، وما ربك بظلام للعبيد. انتهى.
والله تعالى يقول: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة}.
وقال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم}.
فالله تعالى يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحداً، كما قال تعالى: {وما ربك بظلام للعبيد}.
وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة: أن الله يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله.
قال ابن كثير رحمه الله: وقوله {فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء} أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم، يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى، ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال، ويهدي من هو أهل لذلك. انتهى.
وقال ابن سعدي رحمه الله: فيضل من يشاء ممن لم ينقد للهدى. لاحظ هنا {فيضل من يشاء}، أي قال: {فيضل من يشاء ممن لم ينقد للهدى}، ويهدي من يشاء ممن اختصه برحمته، وهو العزيز الحكيم، الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال، ومن عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء، ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. انتهى.
اعتقادهم في أسماء الله وصفاته
قال المؤلف رحمه الله:
يؤمنون بأن لله أسماء حسنى، وصفات عليا، تليق بجلاله سبحانه، وأن الواجب على العباد، وأن الواجب على العباد الإيمان بها على الوجه اللائق بجلاله سبحانه، وأن الواجب على العباد الإيمان بها على الوجه اللائق بجلاله سبحانه، وأن الواجب إمرارها كما جاءت، من غير تحريف، ولا تأويل، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، بل يعتقدون معنى كل صفة على ما تقتضيه في اللغة العربية، على الوجه اللائق بجلاله سبحانه.
قال الشارح الشيخ أحمد الحكمي رحمه الله:
قوله هنا يؤمنون بأن لله أسماء حسنى، وصفات عليا—أسماء الله تعالى: هي كل ما سمى الله به نفسه في كتابه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وهو أعلم الخلق بربه جل وعلا.
وموقف أهل السنة من هذه الأسماء: أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله تسمى الله بها، وأنها حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون}، فهي حسنى قد بلغت من الحسن غايته. وأن لله عز وجل صفات، وهي ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم.
ودليل ذلك قول الله تعالى: {ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم}، أي له الوصف الأعلى والأكمل، والمراد الكمال المطلق من كل وجه.
فيثبت أهل السنة والجماعة لله تعالى ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأسماء الحسنى والصفات العُليا، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}.
وأن الواجب إمرارها كما جاءت إلى آخره، وهذا هو ما عليه السلف الصالح رحمهم الله، منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى زمننا الحاضر، كلهم مجمعون على أنه يجب إمرار هذه الصفات كما جاءت، فلا يتعرضوا للكيفية، وأما المعنى فمعلوم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:
"مذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا: إمرارها كما جاءت، من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تعطيل. انتهى."
وقوله: “من غير تحريف”، فالتحريف في اللغة هو التبديل والتغيير، وصرف اللفظ أو المعنى عن ظاهره الصحيح.
هذا هو التحريف: صرف اللفظ أو المعنى عن ظاهره الصحيح من غير دليل. كما قالت الجهمية في الاستواء: بأنه الاستيلاء، أو فسروه بمعنى الاستيلاء، قالوا: استوى يعني استولى. ولا شك أن هذا تحريف باطل.
وكذلك كتفسير بعض المبتدعة لبعض الصفات بغير التفسير الصحيح الوارد عن السلف الصالح، كمن يؤولون صفة اليد أو يفسرونها بأن المراد النعمة.
وكل هذه من التفاسير الباطلة—وتفصيل هذا في كتب السنة والعقيدة.
اعتقادهم في أسماء الله وصفاته
قال المؤلف رحمه الله:
وأن الواجب إمرارها كما جاءت، من غير تحريف، ولا تأويل، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، بل يعتقدون معنى كل صفة على ما تقتضيه في اللغة العربية، على الوجه اللائق بجلاله سبحانه.
قال الشارح الشيخ أحمد الحكمي حفظه الله:
وقوله: “ولا تأويل”، فالتأويل ينقسم إلى قسمين، وذكر بعضهم ثلاثة أقسام:
الأول: التأويل بمعنى التفسير، وهذا صحيح منقول عن السلف، وقد أكثر منه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، حيث يقول: “تأويل هذه الآية”، يعني تفسيرها. والمراد هنا تفسير نصوص الصفات بالمعنى الصحيح، الوارد عن السلف الصالح، فإن فسرت بغير ذلك، بغير المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو تفسير باطل، وهذا ما صار عليه المبتدعة.
الثاني: التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، كقوله تعالى: {هل ينظرون إلا تأويله}، يعني ما تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامه، فحقيقة الأخبار تأول إلى ظهورها، وحقيقة الأحكام تؤول إلى ظهور آثار من تمسك بها أو خالفها. والمراد هنا أن حقيقة هذه الأسماء والصفات، يعني كيفيتها، لا يعلمها إلا الله عز وجل.
القسم الثالث: ما ذكره الأصوليون، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره، لمرجّح أو قرينة تدل عليه. وعلى هذا، فإن التأويل منه ما هو صحيح مقبول، ومنه ما هو فاسد مردود.
فالصحيح المقبول: ما دل عليه دليل صحيح.
والتأويل الفاسد المردود: هو ما ليس عليه دليل صحيح، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل صحيح، كتأويل المعطّلة في الاستواء بأنه بمعنى الاستيلاء، والمعنى الصحيح: أن الاستواء يأتي بمعنى العلو والاستقرار، من غير تكييف ولا تمثيل، إلى غير ذلك مما ذكره أهل السنة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على لمعة الاعتقاد:
وحكم التأويل على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نيّة، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله، فهذا معفوّ عنه، لأن هذا منتهى وُسعه، وقد قال الله تعالى: {لا يُكلّف الله نفسًا إلا وُسعها}.
الثاني: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصّب، وله وجه في اللغة العربية، فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصًا أو عيبًا في حق الله، فيكون كفرًا.
الثالث: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصّب، وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب، حيث لا وجه له [انتهى]
اعتقادهم في أسماء الله وصفاته.
قال المؤلف رحمه الله:
وأن الواجب إمرارها كما جاءت، من غير تحريف، ولا تأويل، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل..
قال الشارح الشيخ أحمد عبد الله الحكمي حفظه الله:
وأما التعطيل: فهو بمعنى الخلو أو الترك. والمراد: تعطيل أسماء الله وصفاته، أي نفيها أو نفي بعضها.
وأهل التعطيل كما ذكر بعض أهل العلم خمسة أقسام:
القسم الأول: منهم من أثبت الأسماء، وأثبت سبع صفات، وأنكر الباقي، وهؤلاء هم الأشاعرة، ولا شك أنهم ليسوا من أهل السنة.
القسم الثاني: من أثبت الأسماء ونفى الصفات كلها، وهم المعتزلة.
القسم الثالث: من أنكر الأسماء والصفات، وهم غلاة الجهمية، هؤلاء الذين كفّرهم السلف الصالح رحمهم الله.
القسم الرابع: من نفى الأسماء ونفى الصفات الثبوتية، وهي ما أثبته الله لنفسه كالعلم ونحوه. هؤلاء نفوا الأسماء ونفوا الصفات الثبوتية وأثبتوا الصفات السلبية، وهي التي نفاها الله عن نفسه، كالظلم، والنوم، والسِنة، ونحو ذلك.
يقولون: لا نثبت له علمًا، لكن نقول: ليس بجاهل، لا نثبت أنه سميع، لكن نقول: ليس بأصم، ونحو ذلك. وهؤلاء القرامطة ومن نحا نحوهم.
القسم الخامس: من يعطّل النفي والإثبات، فلا يصفونه بصفة ثبوتية، ولا صفة سلبية.
يقولون: لا نقول إنه يرضى، ولا نقول إنه لا يرضى، لا نقول إنه لا موجود، ولا معدوم، ونحو ذلك، وهؤلاء هم غلاة القرامطة والباطنية.
والفرق بين التحريف والتعطيل:
أن التعطيل: نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة.
والتحريف: تفسير النصوص بالمعاني الباطلة، أي على قول هؤلاء المبتدعة، أي أن المبتدعة يحرفون هذه النصوص عن معانيها الصحيحة إلى المعاني الباطلة، وقد يحرفون اللفظ كما مر معنا.
وأما التكييف: فهو طلب صورة الشيء أو حكاية كيفية الصفات، بحيث يجعل لها كيفية معلومة.
وأما التشبيه: فهو إثبات مشابه لله فيما يختص به تعالى، وهذا كفر، لأنه شرك بالله، يتضمن النقص في حق الله تعالى، لأن فيه تشبيه المخلوق بالخالق العظيم.
وأما التمثيل: فهو إثبات مماثل لله فيما يختص به، وهذا كفر أيضًا، وتكذيب لله في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء}، ويتضمن أيضًا النقص في حق الله، حيث يمثل هذا المخلوق الناقص بالخالق الكامل، في جميع صفاته وأفعاله وذاته.
والفرق بين التمثيل والتشبيه: أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، بخلاف التشبيه.
والفرق بين التمثيل والتكييف: أن التمثيل هو ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل،
وأما التكييف: فهو ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل.
مثال التمثيل: أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان.
مثال التكييف: أن يتخيل في نفسه ليد الله تعالى كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين. وهذا حرام ولا يجوز
اعتقادهم في أسماء الله وصفاته
قال المؤلف رحمه الله: (بل يعتقدون معنى كل صفة على ما تقتضيه في اللغة العربية، على الوجه اللائق بجلاله سبحانه.)
قال الشارح الشيح احمد الحكمي حفظه الله:
وقفنا عند قوله رحمه الله:
بل يعتقدون معنى كل صفة على ما تقتضيه في اللغة العربية، على الوجه اللائق بجلاله سبحانه.
أقول: هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هم يثبتون معاني هذه الصفات كما جاءت في اللغة العربية، لأن معناها معلوم، لكنهم يفوضون الكيفية، لأن كيفية هذه الصفات مما استأثر الله تعالى بعلمه.
والله تعالى يقول:
{يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما}
إذن: الكيفية لا يمكن أن نحيط بها، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يخوضون في شأنها، بل يفوضون ذلك، أو يفوضون أمر ذلك إلى الله عز وجل.
ولهذا ثبت عن جمع من السلف رحمهم الله أنهم يفوضون الكيفية إلى الله عز وجل. وقد أخرج البيهقي كما في “السنن الكبرى” بسنده عن الوليد بن مسلم، أنه قال:
سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، يعني أحاديث الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية. انتهى.
وهذا دليل واضح على أن السلف، أو أهل السنة والجماعة، يفوضون الكيفية، إذ لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه.
ولهذا جاء واضحًا وصريحًا في الأثر المشهور عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، جاء صريحًا عنه ذلك، فقد روى جعفر بن عبد الله قال:
جاء رجل إلى مالك بن أنس، فقال: يا أبا عبد الله (هذه كنيته)، قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟
قال: فما رأيت مالكًا وجد من شيء كموجدته من مقالته، أو كموجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء، يعني: تصبب عرقًا، لأن هذا السؤال سؤال عظيم، وما كان السلف الصالح يسألونه، بل كانوا يفوضون هذا الأمر إلى الله.
لهذا علاه الرحضاء، وأطرق القوم، يعني: ينتظرون إجابته، جعلوا ينتظرون ما يأتي منه. قال: فسُرِّي عن مالك رحمه الله، فقال:
“الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول”،
يعني: معلوم المعنى، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالًا، وأمر به فأُخرج.
هكذا أخرجه الدارمي في كتابه “الرد على الجهمية”، وكذلك أخرجه اللالكائي في “شرح اعتقاد أهل السنة”، وكذلك أخرجه البيهقي في كتاب “الأسماء والصفات”، وجود إسناده الحافظ في “الفتح”، وله طرق عن الإمام مالك، وهو أثر صحيح، صححه جمع من أهل العلم.
ولهذا تناقلوه، أي: تناقلوا هذا الأثر عنه، بل عدوا هذا الأثر قاعدة في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات.
وقد رُوي هذا الأثر أيضًا عن شيخه، أو نحو هذا الأثر عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله، أنه قال:
“الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق.”
ورُوي أيضًا عن أم سلمة رضي الله عنها، لكن ذكر أهل العلم أن ذلك لا يصح عنها، أي: لا يصح السند إليها.
قال الذهبي رحمه الله:
“العلو هذا ثابت عن مالك”،
أي: عن الإمام مالك، وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها.
انتهى.
أقول: بل كيفية الصفات كلها لا نعقلها، أي: لا نعرف كيفيتها.
وفي قول الإمام مالك رحمه الله هنا: “الكيف غير معقول”، أي: لا يمكن أن تدركه عقولنا أو تحيط به، فإن الله أعظم من أن تدركه العقول، أو أن تدرك العقول كنه ذاته وصفاته.
والله تعالى أعلم